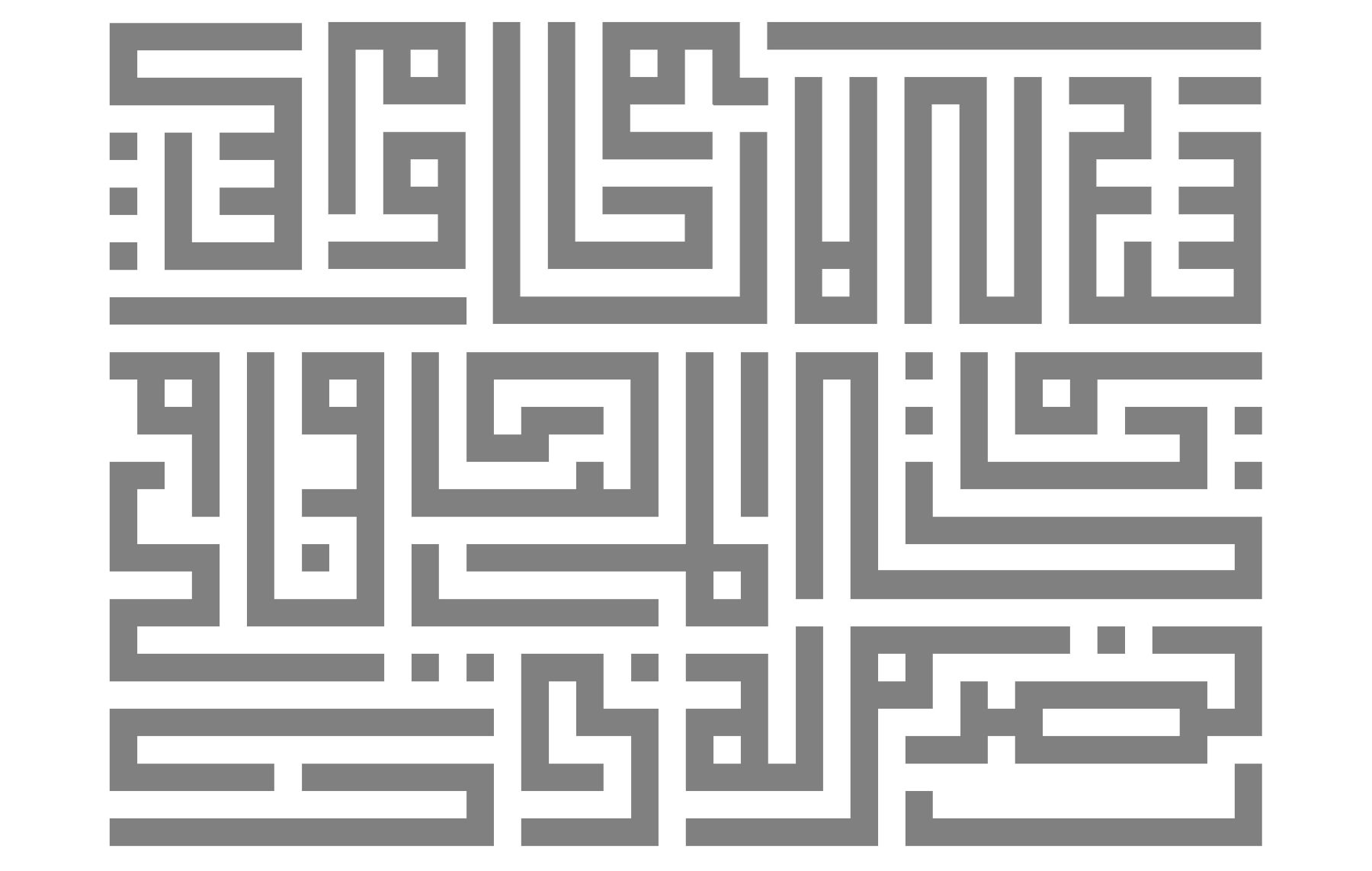أتذكّره بكل تفاصيله، كان يومًا من أيام صيف الرياض اللاهب. الشاحنة الواقفة أمام شقتنا في حي الجراديّة تكتظ بأثاثنا المتواضع لتنقله إلى شقة جديدة في الحي ذاته. لأول وهلة، يبدو هذا الحدثُ عاديّا، ولكنه كان للفتى ذي الثلاثة عشر عامًا حدثًا دراميًّا. مجبرًا على مغادرة هذه الشقة التي قضيتُ فيها سنوات صباي، كان أبوعبدالله الصغير بين جنبيّ يسلّم مفاتيح غرناطة لفرناندو وإيزابيلا، والأفق مزيج غامض من عصرين: أحدهما يموت، والآخر يوشك أن يولد. ربما هي الألفة، فأنا على - دين أبي الطيب - "خُلقتُ ألوفًا"، ولكنّ انتقالًا إلى شقة جديدة لا تبعد عن شقتنا الأولى أكثر من سبع دقائق لا يستحق كلّ هذه اللوعة التي كانت حينها كافيةً لتضعني في مصاف شعراء المنفى. لا أعرف سببًا يفسر ما كان من أمر تلك الجنائزيّة غير إحساسي بالفقد تجاه شارعنا. صحيحٌ أن عائلتي ستظل هي عائلتي، وسيظل حيُّنا هو حيُّنا غير أن الشارع الذي ترعرعت فيه سيذهب بهذا الانتقال إلى غير رجعة. وفي حي شعبيّ مثل حي الجراديّة، كلّ شارع هو عالم مستقل وهويّة قائمة بذاتها، كل شارع له حصته الخاصة، من: المناخات، والفنون، والولاءات، والأعراف، والوجوه، وحتى الروائح والظلال، وبهذا المعنى لا يكون الانتقال مجرد تبديل شوارع، ولكنه في حقيقته تبديل عوالم.
يعيش الناس في البيوت، ويمرون بالشوارع. بالنسبة للفتى الذي كنتُه كان الأمر مقلوبًا، كنتُ أعيشُ في الشارع وأمرّ بالبيت. بولعٍ كهذا، لم يجد والدي أي مشقة في اختراع عقاب رادع لأي خطأ أرتكبه، فقد كان العقاب جاهزًا: الحرمان من الشارع، وحين كانت تنقضي العقوبة كانت أركض إليه ركض الظامئ إلى النبع (في اللغة الشارع متصل بدلالات الريّ والسقي، ومن معانيه المواضع التي يُنحدرإلى الماء منها.. فتأمل). كان الشارع بوصفه ورشة مفتوحة من الحيويّة والحريّة والتنوع هو المعادل الموضوعيّ للحياة ذاتها. ففي حينا الشعبيّ، أتاح لي الشارع - مبكرًا - فرصة مصاحبة الملائكة والشياطين معًا، وأعطاني فرصة لأعجن نفسي في فرن الهُويّات المختلفة، هُويّات سكان حينا الذين لا ينحدرون فقط من كل مناطق المملكة، ولكن من مناطق مختلفة من العالم. وجوه عربيّة وآسيويّة وإفريقيّة كثيرة تصطف الآن في الذاكرة، وتصطف من ورائها لغات وأفكار وتقاليد، وحتى مطابخ وأذواق تسللت كلها إليّ جراء اندماجي المبكر في هذا المزيج البشريّ الحارّ.
لا أعرف إن كانت عبقريّة البشر ستتفتق يومًا ما عن فحوص طبيّة أكثر تطورًا ودقةً نقيس بها غير الماديّ كما نقيس الماديّ، لكنني أعرف أن فحوصًا كهذه ستجد ولا شك قطعًا من الأسفلت في دمي. ما زلت حتى يومي هذا أتنقل بين شخصيات متعددة ونسخ مختلفة منيّ، أحيانًا أشعرُ أنني من نفسي في زحام، وهذا الزحام ما كان له أن يزدهر فيّ لولا زحام شوارع وسط الرياض التي كوّنتني. في هذه الشوارع شهدتُ مبكرًا الصحافة الحرّة وهي تطبعُ على الجدران، رأيتُ الليالي وهي تعجّ بالموهوبين في كل فنّ، ابتداءً بقرّاء القرآن الكريم، وليس انتهاءً بمغني الراب، ضحكتُ حتى آخر دمعة مني مع أساتذة السخرية الكبار في حيّنا، وهم يحولون كلّ تراجيديا الواقع إلى كوميديا خلّاقة، ركضتُ مع اللاعبين في دوري كرة القدم، هذا الدوريّ الأزليّ- الأبديّ الذي لا أحد يعرف بالضبط متى بدأ في حيّنا أو متى سينتهي.
لاحقًا، تطاول بي السفر، وتداخلت فيّ أطيافُ المكان، ولم يبق من المدن إلا وجوهُها، ووجوه المدن الشوارع. أقلّب بين يديّ الآن جوازات سفري الثلاثة ولا أرى من المدن التي تحدثتُ طويلًا معها إلا شوارعها. أرى القاهرة موجزةً في شارع المعز لدين الله الفاطمي، عمّان في شارع ما (أحتفظ باسمه لنفسي) في ضاحية الرشيد، الخرطوم في أواخر شارع النيل بعد جسر المنشية، بغداد في شارع المتنبي، لندن في شارع فكتوريا، ونيويورك بكلّ ما فيها أراها مختصرةً في نسختي الخاصة من الشارع الخامس، النسخة التي تخرج بي من منزلي في أعلى منهاتن لتقف بي بعد ثلاث ساعات من المشي أمام جسر بروكلين.
قبل أيام كنت أقول لنفسي لا بد أنّ من صمّم شوارع منهاتن كان شاعرًا، ليست لأنّها جميلة (في الحقيقة العكس هو الأقرب للصواب) ولكن لأنّ تصميمها في حد ذاته هو استعارة شديدة الدقة للحياة نفسها. منهاتن استعارة واضحةٌ لا لبس فيها، بضعة شوارع طوليّة تنتظم هذه الجزيرة الصغيرة من شمالها إلى جنوبها، وتتصل هذه الشوارع الضخمة فيما بينها بمجموعة من الجوادّ والطرق العرضيّة الذاهبة من الشرق إلى الغرب. المدينة إذن آخذةٌ شكل المسارات الممتدة، وحين تمشي في الشارع الخامس مثلاً، قد ينشغل عقلك بالتفكير فيما يحدث من فنون وأحداث ومشاهد في الشارع السادس الذي بجانبك، تمامًا كما هو الأمر في الحياة، تسير أنت في طريقك ولكنّ عينيك لا تكفان عن التطلع لطرق الآخرين. ربما تكون هذه الاستعارة حاضرة في شوارع المدن الأخرى، غير أنّها غامضة غموض دوائر الطرقات المتداخلة لهذه المدن، بينما هي في منهاتن استعارة واضحة لا تحتاج إلى شارح.
بالإضافة إلى هذه الاستعارة الكليّة للحياة، أمدتني شوارع منهاتن باستعارات جزئيّة للقصيدة. طوال سنة ونصف انشغلت فيها بكتابة ديواني الصادر حديثا (لم يعد أزرقا)، منحتني هذه الشوارع مخرج الطوارئ كلما غلّقَ المعنى أبوابه في وجهي. تبدأُ القصيدةُ نهرًا، ثم يحدث أن يستحيل التدفّق إلى تصلّب، تتخثر المياه في الأعماق وأشرع في مكابدة حجرٍ في اللغة، حجرٍ في المخيلة، وحتى حجرٍ في الحس. كنت حين يحدث هذا، أضع هذه الحجارة في جيبي وأقفز إلى الشارع هائمًا على وجهي لعدة ساعات، وفي العادة لا أعود إلا وقد عادت الحجارة في جيبي أنهارًا لا تكفّ عن الجريان. هذا المشي الطويل المنتج في شوارع نيويورك هو من جعلني أصل إلى هذه الخلاصة: في المشي، من يمشي حقًا هو العقل، القدمان مجرد تمويه. ربما تكون تسمية (المشائيّة الأرسطيّة) ناتجةً – كما يقول المؤرخون- عن خلط في الترجمة عن اليونانية القديمة بين كلمتين تشير إحداهما إلى فعل المشي وتشير الثانية إلى أروقة مدرسة أثينيّة، ولكن الصلة بين المشي والتفكير في تاريخ العقل أوضح من أن تحتاج إلى هذا الشاهد. العقل يمشي، هذا ما تقوله لنا السنوات العشر الحرجة التي قضاها الغزالي سائحًا بين العراق والحجاز والشام، وهذا ما تقوله خطوات هايدجر الدائمة في الغابة السوداء، وما تقوله لنا أيضًا دقات الساعة الخامسة في مقاطعة كونغيسبرغ حيث كان كانط يبدأ برنامج المشي اليومي، برنامج التفكير بالقدمين.
يكتظ رأسي بشوارع أخرى كثيرة، ولكن عليّ الآن أن أغلق قوس هذه الكتابة وأخرج لألتقي بصديق أمريكيّ، هذا الصديق ترجمتُ له مرةً مقطوعة لأمل دنقل فدارات عيناه من الدهشة، في اليوم التالي أرسل لي رسالة يقول فيها: مقطوعة البارحة غيّرت علاقتي بقدميّ وبظلي وبالشارع الذي أسير فيه. كيف يمكن للشعر -حتى ولو كان مترجمًا - أن يعيد تعريفنا حتى بما نظن أننا نعرفه من أنفسنا؟
سأدع لمقطوعة أمل دنقل الكلمة الأخيرة:
"في الشارعْ..
أتلاقى في ضوء الصبح بظلي الفارعْ
نتصافحُ بالأقدام"