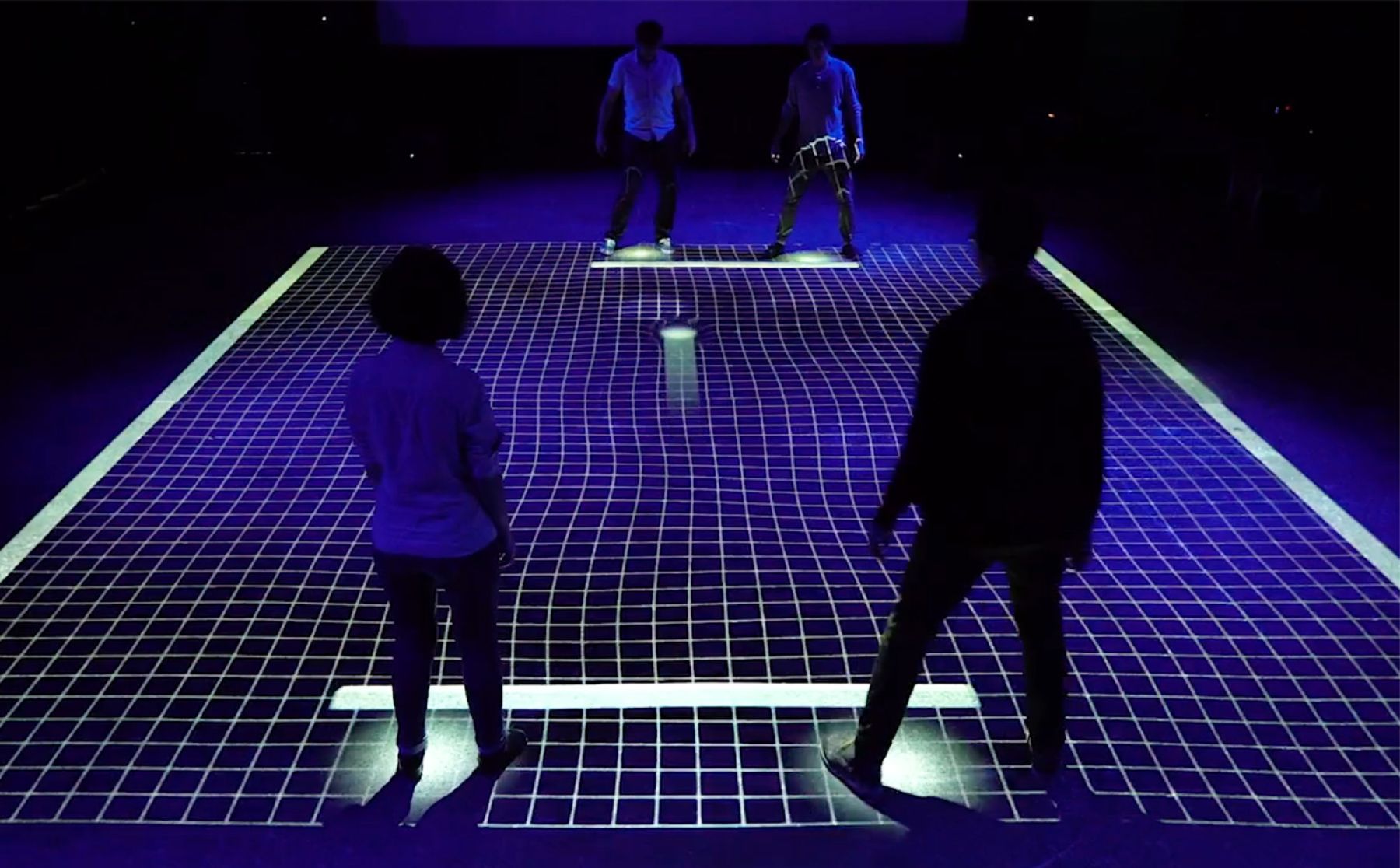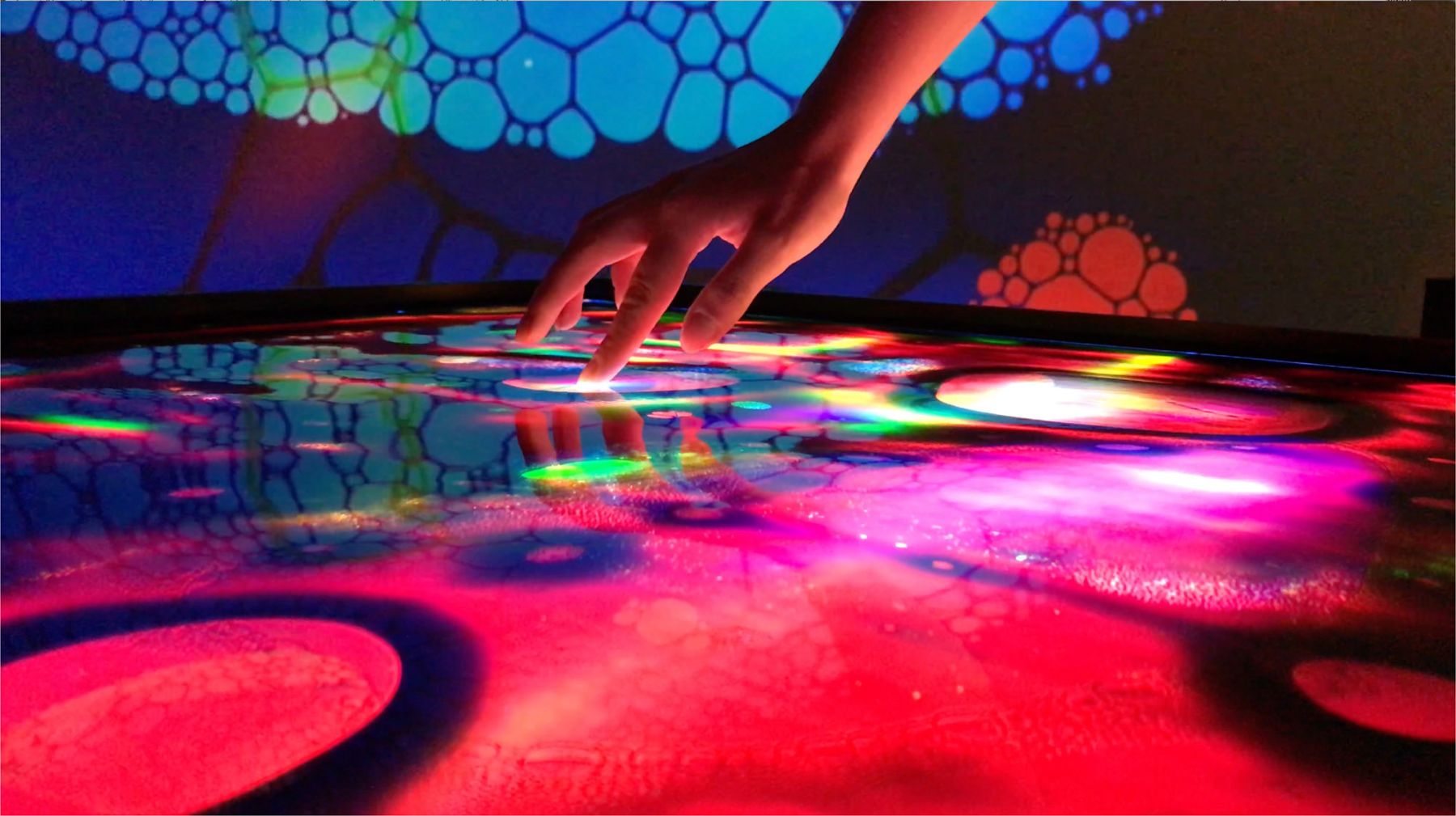بهذه المقولة الرائعة، نقض الفيلسوف والمؤرخ الألماني فريدريك شيلر (١٧٥٩ - ١٨٠٥) التصورات السلبية التي كانت سائدة في عصره عن اللعب بصفته نشاطاً عبثياً وترفاً لا فائدة منه، بل أسس لرؤية جديدة تعيد اللعب إلى واجهة الحضارة بصفته أحد أكثر النشاطات المؤثرة في الثقافة الإنسانية. اليوم يُعرّف اللعب بأنه نشاطٌ حر، يجري ضمن مكان وزمان محدديْن وبقواعد خاصة تفصله عن بقية أنشطة الحياة اليومية. إنه الوقت الذي يكون فيه الإنسان في قمة إبداعه وذروة طاقاته الخلاقة، إذ ينأى بنفسه أثناء اللعب عن قوانين العالم الخارجي وسلطة الواقع التي عادة ما تكبله، وبالتالي يكون في أنقى حالاته الإنسانية.
من هنا، التفت التربويّون والفلاسفة وعلماء النفس والبيولوجيّون إلى العديد من الفوائد الناتجة عن اللعب: بدايةً من تحريره للطاقة الفائضة عند الطفل، إلى كونه وسيلة لتقوية البدن وتمرين عضلاته ومهاراته الذهنية، مروراً بالنظرية القائلة بأنه يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وإدماج الفرد في مجموعته، وحتى مدرسة التحليل النفسي التي ترى أن اللعب يهدف إلى تخفيف القلق واستعادة التوازن النفسي، حيث استنتج العلماء من خلاله طرقاً عديدة لعلاج الأطفال المضطربين نفسياً. ولا يوجد تعارض بين كل هذه النظريات وغيرها الكثير من جوانب اللعب التي لا زالت تُكتشف، إذ يمكن أن تشمل لعبة واحدة جميع تلك الفوائد في الوقت نفسه. لكن كل هذا لا يفسر سوى جزء بسيط من نزعتنا للعب، ولا يحل الغموض الكبير الذي يفسر انجذابنا له.
ما يجمع بين كل هذه النظريات هي أنها تفترض وجود هدف، وهو أمر لا يتفق مع طبيعة اللعب المتحررة. فالأطفال يمارسونه عشوائياً وليس إشباعاً لحاجة كالأكل والنوم، والكبار قد يمارسونه عفوياً لتجزية الوقت أو حتى في أشد لحظات انشغالهم. ولا تفسر أي من تلك النظريات لماذا يقترن اللعب لدينا بالنشوة والمرح. فالفوائد السابقة يمكن التحصل عليها عبر أنشطة أخرى جادة لا تشترط المتعة لتحققها، وفي حال غياب إمكانية اللعب فإن الإنسان بقدرته الشاسعة على التأقلم سيخترع طرقاً أخرى لاستعادة توازنه النفسي وتحقيق نموه الجسدي والذهني. وهكذا نستنتج أن فرادة اللعب تكمن فقط في خاصية المتعة المتحررة التي تميزه عن بقية الأنشطة الهادفة. إنها ليست خاصية ضرورية للنمو والنجاة وإشباع الحاجات الأساسية، لكن هنا بالذات يكمن سحرها.
إن اللعب قرين الإبداع لأنه متحرر من كل الأهداف، فلا مكان للخوف من الفشل أثناء اللعب، إذ أن متعة اللعب لا تكمن في الوصول بل في الطريق الذي تمر عبره. وليس ثمة هدف إنتاجي للّعب يسعى لأي كسب مادي، وبالتالي ليس ثمة ضغوط، بل هو تخففٌ من كل الضغوط لأنه يملك قوانينه الخاصة التي تعزله عن العالم العملي. إنه عملية استكشاف يمكن لها أن تتكرر وتعاود التجربة إلى ما لا نهاية، وفي كل مرة تبدأ فيها اللعب يتجدد السحر، بل يزداد كلما زادت ألفتنا مع اللعبة، عبر المتعة الناتجة عن تمكننا من مهارات لعبٍ واظبنا على تطويرها، وهذه المتعة المثمرة هي التي تجعل الإنسان لاهياً وحكيماً في الوقت نفسه. إذاً ليس اللعب لهواً خالصاً ولا جِداً خالصاً، فمهما حاولت تصنيفه فهو عصيّ على الالتزام بصيغة واحدة نظراً لتعدد جوانبه.
يدرك اللاعبون أنهم بمجرد فراغهم من اللعب سيعودون إلى أعباء ومتطلبات الحياة العملية، كما أن الطفل الذي يلعب مرتدياً أزياء الكبار ومحاكياً شخصياتهم يدرك أنه لن يصبح شرطياً أو طبيباً لمجرد تجسيده للدور، لكن طالما استمرت اللعبة فالسحر مستمر. ليس من الغريب إذا أن تُوصف مسرحيات شكسبير مثلاً بأنها نوع من اللعب، إذ “يلعب” الممثل مؤقتاً أدواراً إنسانية، في إطار زماني ومكاني محدود، ويندمج الجمهور بجدية تامة رغم أنه يدرك حقيقتها المسرحية، لكنها تؤثر فينا وتزيد من إنسانيتنا وقدرتنا على التعاطف. وكذلك الإنسان على مسرح الحياة يشحذ ملكة الابتكار ويتصور حالات متنوعة خارج نطاق تجاربه ويوسع خياله من خلال اللعب. وهذا لا يعزز فحسب قدرته على تقدير الجمال وخلقه، بل أيضاً على أن يكون نفسه كائناً جميلاً.